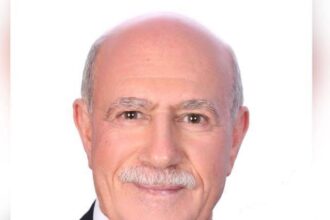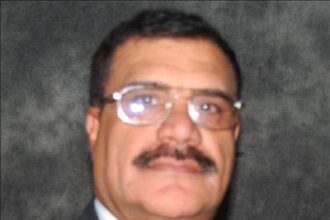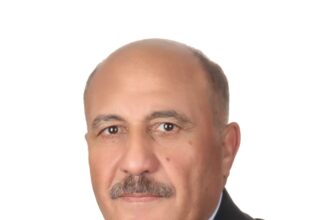صراحة نيوز ـ باسل النيرب
يستضيف الأردن لاجئين من 49 دولة، وتشكّل نسبتهم 1.4% من إجمالي سكان الأردن، وفق تقرير الاتجاهات العالمية 2023 الصادر عن المفوضية. وتبرز بين الحين والآخر ممارسات وتصرفات عنصريّة فرديّة في الشبكات الاجتماعيّة؛ كالتنمّر والإساءة، وهي مظاهر لم تقتصر على جنسيّة لاجئ دون آخر، وإنّما طالت جميع اللاجئين من الفلسطينيين والسوريين والوافدين المصريين، حتى وصل الأمر إلى حد الاعتداء عليهم.
اعتمد الخطاب في الشبكات الاجتماعيّة على إعادة تركيب المفردات المستخدمة في المجتمع الأردني لتشكل بنية فكرية جديدة، ومن ثم إعادة تشكيل مفاهيم جديدة للهويّات المحليّة الخاصة، وتمثلت أهم هذه الأدوار في إثارة الرأي العام أو إعادة توجيهه، أو في تشتيت الرأي العام، أو في التشويه السياسيّ الإلكتروني، الأمر المرتبط بالتحريض على الآخر والتعبئة ضدهم، وفي المقابل العمل على تضخيم الأنا لدى الطرف المقابل الذي ينشط في التحريض على الفئات الأخرى لتعزيز مفهوم المواطنة والأحقية في المناصب والأموال والامتيازات التي يعتقدون آنها منحت لغيرهم وحرموا منها.
تنطلق الدراسة من أهميّة دور وتأثير شبكات التواصل الاجتماعيّ التي أضحت متغيرًا مهمًّا في تشكيل الآراء في ظل المتغيرات المعرفيّة والاجتماعيّة والاقتصاديّة والسياسيّة التي يشهدها العالم، ومقاربتها لظاهرة الشعبويّة التي تؤدي إلى نشر العنصريّة والكراهية في البيئات الرقمية، وكيف وظَّف الشعبويون شبكات التواصل الاجتماعي لبث أفكارهم، وتأثير الشبكات الاجتماعية في تنامي الخطاب العنصري والكراهية من خلال دراسة فترة زمنية محددة ووفق مجموعة من الكلمات المفتاحية التي وُلِّدت بواسطة الذكاء الاصطناعي لدراسة الحالة.
ووفقًا لذلك، تأتي هذه الدراسة كدراسة حالة لمنصة إكس تحديدًا، وذلك خلال الفترة من يناير إلى يونيو 2024.
أهداف الدراسة
تسعى الدراسة إلى مقاربة الأسئلة التالية:
ما هي إجمالي الجهات التي تناولت تمظهرات العنصريّة والكراهية في البيئة الرقميّة الأردنيّة؟
ما هي طبيعة المحتوى المعزِّز للعنصريّة الرقميّة ونشر الكراهية ضمن البيئة الرقميّة الأردنيّة؟
ما هي أبرز الآراء والمطالب التي يسعى خلفها (الأفراد و/أو الجهات) عند نشر المحتوى العنصريّ والكراهية في البيئة الرقميّة؟
ما هو موقف الأنظمة والتشريعات من المحتوى المعزِّز للكراهية والعنصريّة في المجال الرقميّ الأردنيّ؟
منهج الدراسة وأدوات جمع البيانات
تنتمي الدراسة إلى البحوث الوصفيّة التي تُعنَى بدراسة واقع الأحداث والظواهر والآراء، وتحليلها وتفسيرها بهدف الوصول إلى استنتاجات مفيدة؛ إما لتصحيح الظاهرة، أو تحديثها، أو استكمالها، أو تطويرها، عبر التشخيص الذي يسعى إلى لدراسة كافة المتغيرات ذات الصلة بموضوع الدراسة، وتحديد العلاقات الكامنة وراء الحقائق التي جرى جمعها. واعتمد الباحث أيضًا على الملاحظة لجمع البيانات والمعلومات في هذه الدراسة، وغطت الدراسة منصة إكس خلال الفترة من يناير إلى يونيو 2024، باستخدام أداة Meltwater من خلال بناء سلسلة من الكلمات المفتاحية ذات العلاقة المباشرة. وقد جرى استبعاد إعادة النشر من خلال التحليل الإحصائيّ كما تم استُبعِدت الموضوعات غير ذات العلاقة بمنهج الدراسة، واستبعاد الإعلانات وكل ما لا يمتّ لموضوع الدراسة بصلة.
المدخل النظري
تحتضن منصات التواصل الاجتماعي أفكارًا وأيديولوجيّات متعددة، ومن أهم ما تتبناه تلك المنصات الأفكار السياسية وما يدور حولها، والتي تعمل في سبيل نشرها ضمن مجموعة من الاستراتيجيات، ومنها:
استراتيجية الإعلام: تُقدَّم المعلومات إلى الجماهير الأساسيّة، وهم أعضاء الشبكة والمتعاطفون معها بهدف دعم اتجاهاتهم ومساعدتهم في اتخاذ قراراتهم.
استراتيجية الإقناع: تُستخدَم لبناء ودعم العلاقات الاستراتيجية مع الجماهير الأساسية المنتمية إلى الشبكة الاجتماعيّة، وإحداث تغيير مقصود في معارف واتجاهات وسلوكيات جمهور معين.
استراتيجية بناء الإجماع: تُستخدَم في الغالب لبناء علاقات استراتيجية مع البيئة الخارجيّة، عندما يظهر تعارض بين أهداف الجهات المسوقة وبين مصالح واتجاهات الجماهير، وإلى إيجاد أرضية مشتركة تحقّق الحد الأدنى من التفاهم بين الجهات المُسوّقة والجمهور المستهدف.
استراتيجية الحوار: يفتح المسوّق السياسي وسائله الاتصالية ليعبِّر إلى جماهيره عن آرائه وتوجهاته ومقترحاته.
وتستخدم الشبكات الاجتماعيّة مجموعة من التكتيكات لتحقيق أهداف محددة عبر تسويقها للأفكار، ومن بين هذه التكتيكات:
التمكين: وتتضمن قيام المنصة الاجتماعيّة بتمييز نفسها عن غيرها من خلال تحقيق التواصل والترابط بين أعضائها وتحديد اهتمامات الشبكة بطريقة متكاملة بينها، وتوافقها مع اهتمامات المستخدمين من جانب آخر.
الهجوم الجانبي: ويعني استهداف مجموعات من المستخدمين كانت مستبعدَة أو متجاهَلة قبل ذلك.
الهجوم الشامل: ويعني توجيه الجهود الاتصاليّة إلى كل المستخدمين لجذب أكبر عدد منهم.
الهجوم الجزئيّ: ويعني توجيه الجهود الاتصاليّة إلى قطاعات ومُستخدمين معينين.
الهجوم المباشر: ويعني توجيه انتقاد مباشر للمنافسين.
الهجوم المضاد: ويأتي ضمن مرحلة ردّ الفعل، ويُركَّز فيه على الأعضاء الموالين والمؤيدين للشبكات المنافسة.
الدبلوماسية: وهي بمثابة تكتيك دفاعيّ تقوم من خلاله الشبكة بالتعاون مع غيرها، والتي تتباين معها في المبادئ في شن حملات مشتركة.
الهجوم الوقائي: وهو بمثابة تكتيك دفاعيّ، ويبدأ بالهجوم على المنافسين قبل التعرض للهجوم من قبلهم، مثل استخدام الإعلان الهجوميّ لكشف عيوب ونواقص المعارضين.
الانسحاب التكتيكيّ: ويعني التخلي عن المؤيدين المترددين والتركيز على الموالين الأساسيين للشبكة واسترضاءهم، وإعادة طمأنتهم على سياسة الشبكة ومواقفها.
التركيز على الحاجة إلى التغيير: حيث تؤكد الشبكة وتدعو إلى التغيير في الأوضاع القائمة.
وفي ظلّ هذا الفهم لشبكات التواصل الاجتماعيّ، يمكن توضيح المقصود بالعنصريّة والكراهية التي تستند في خطابها على الشعبويّة، والتي تقوم بدورها في تآكل المفاهيم والقيم الإعلامية؛ مثل المصداقيّة والموثوقيّة ومصدر الخبر. لقد أدت الشعبوية مع غيرها من المعطيات إلى تداول الشائعات، وإلى نشر التحريض والكراهية والعنف والتنمر ونظريات المؤامرة وغيرها من المظاهر السلبية التي تعجّ بها البيئة الرقمية في الإعلام.
العنصريّة والكراهية كمظهر من مظاهر الشعبويّة
أشار موقع البروميتر العربي أن تتفشى العنصريّة بطرق مختلفة، وتنال من ضحاياها بسبب اللون أو العرق أو النسب العائليّ أو الاختيار المهني من دون علم من يمارسها أنه «عنصري». وفي العام 1965، اعتمد المجتمع الدوليّ الاتفاق الدوليّ للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصريّ، وبموجبه تلتزم الدول الموقعة القضاء على جميع أشكال التمييز العنصريّ. أمّا تعريف التمييز العنصريّ وفقًا للقانون الدوليّ، فهو: «أي تمييز أو استثناء أو تقييد أو تفضيل قائم على أساس العرق أو اللون أو النسب أو الأصل القوميّ أو الإثنيّ، ويستهدف تعطيل أو عرقلة الاعتراف بحقوق الإنسان والحريات الأساسية أو التمتع بها أو ممارستها على قدم المساواة في الميدان السياسيّ أو الاقتصاديّ أو الاجتماعيّ أو الثقافيّ أو في أي ميدان آخر من ميادين الحياة العامة». وعلى الرّغم من تصديق غالبية دول العالم على الاتفاقية؛ إلا أن الهوة بين التوقيع والالتزام شاسعة.
وحسب دراسة استقصائيّة أجراها «الباروميتر العربيّ للأبحاث» عن العنصريّة في عدد من الدول العربية عام 2022، فقد بلغت نسبة المعلنين بوجود مشكلة التمييز العنصريّ في الأردن 63%، حيث لا تخلو شبكات التواصل الاجتماعيّ من التحريض المتواصل ضد الآخر، وتحديدًا بين المكونات الشرق-أردنية والأردنيين من أصول فلسطينيّة. وعلى سبيل المثال نشر الباحث ناصر الرحامنة دراسة بعنوان «خطاب الكراهية في شبكة الفيسبوك»، تناول مفهوم أشكال الكراهية المتداول عبر شبكات التواصل الاجتماعيّ، جاء تشويه الحقائق وتكذيبها في المرتبة الأعلى، وعدم القبول باختلاف مع الآخرين المختلفين عني.
وفق هذا السياق، لا بدّ من التنويه على أن الدستور الأردنيّ كرَّس مبدأ المساواة وعدم التمييز على أساس العرق أو اللغة أو الدين، ونص على أن «الأردنيين أمام القانون سواء لا تمييز بينهم في الحقوق والواجبات، وإن اختلفوا في العرق أو اللغة أو الدين».
كما تنصّ المادة 14 من الدستور على أن «الدولة تحمي حرية القيام بشعائر الأديان والعقائد طبقًا للعادات المرعيّة في المملكة ما لم تكن مخلة بالنظام العام أو منافية للآداب». ونصّ قانون الإعلام المرئي والمسموع على التزام وسائل الإعلام المختلفة بعدم نشر أو بثّ كل ما من شأنه إثارة النعرات الطائفيّة والعرقيّة، أو ما من شأنه الإخلال بالوحدة الوطنية أو الحض على التفرقة العنصريّة أو الدينيّة.
ظلّت ظاهرة العنصرية والكراهية في الأردن محصورة في الهتافات الهوياتيّة، وقد اصطبغ سلوك الأردنيين منذ عام 2016 على وسائل التواصل الاجتماعيّ بصبغة واضحة من خطـاب الكراهية وتعبيراته الإقصائية التي تؤسس للاستقطاب والانقسام الاجتماعيّ، حيث يشكل خطاب الكراهية البيئة الخصبة لتفشي العنصريّة.
على مقاعد الدراسة الأمر يبدو تمامًا مثل الشارع ومدرجات كرة القدم، حيث كتبت الصحفية نور عز الدين مقالًا بعنوان «تجربة شخصيّة: فلسطينيو الأردن.. أزمة جيل بهوية ثالثة»، حيث أشارت إلى أن أحد أساتذة كلية الصحافة والإعلام -حيث درست-: “وزعنا وفقًا لأسماء العائلات، حسب الأصول الأردنية أو الفلسطينية، إذ كان يسأل كلًّا منّا: «ما اسم عائلتك؟، أنت فلان من مدينة أو قرية كذا، أما نحن ذوو الأصول الفلسطينية فكانت أماكننا مختلفة». وتضيف: «أعرف بعض الطلبة تتشابه أسماء عائلاتهم مع أسماء عائلات أردنية، ومنعًا للحرج، وتعزيزًا لعلاقتهم بالأساتذة الجامعيين، كانوا يقولون: ‘أنا من عيلة كذا، بس مش الفلسطينية، الأردنية، من قرية كذا‘».
عندما يرحل اللاجئ إلى مكان آخر غير وطنه فإنه يأخذ معه موروثه الثقافي ومخزونة اللغوي، وبفعل هذا التنقل تشكلت بعض الأمثلة التي ارتبطت بهذا اللجوء، منها ما يقال للفخر، ومنها ما يُقال على سبيل الاستهزاء أو السخرية التي يمكن تمريرها أو استخدامها عقب نقاش حاد وعميق.
وفق ذلك يمكن حصر خطاب الكراهية في ثلاثة مفاصل أساسية، وهي:
التحريض على العنف.
الإساءة إلى للآخر.
التمييز العنصريّ على أساس الهوية، والإثنية، والعرق، والدين.
وضمن مستويات خطاب الكراهية، يمكن تقسيم الخطاب إلى المستوى الوطنيّ الذي يمس أشخاص أو مجموعات معينة ثم يكبر؛ والمستوى الإقليميّ، حيث تُرسَّخ من خلاله الميول الطائفيّة.
ومن العلامات الواضحة على انتشار خطاب الكراهية ذكر بعض التوصيفات السلبيّة، وهي من الإشارات المبكرة التي يمكن قياسها مثل عبارات سرقة، واحتيال، وعنف، وتحريض، وخاصة في الدعوة إلى الكراهية القوميّة أو العنصريّة. كذلك ينطبق الأمر التجريد من الإنسانية لخلق صورة سلبية للجماعات الأخرى مثل المهاجرين أو اللاجئين.
تتشكل مكونات خطاب الكراهية، وفق التصنيف التالي:
المواقف المتحيزة، متمثلةً في:
الصور النمطية، والخوف من الاختلافات، واللغة غير الشاملة، وتبرير التحيزات بالبحث عن الأشخاص ذوي التفكير المماثل، وقبول المعلومات السلبية أو المُضللة، وحجب المعلومات.
الأفعال المتحيزة متمثلةً في:
التنمر، والسخرية، والافتراءات، والتجنب الاجتماعيّ، والتجريد من الإنسانية، ونكات الاستخفاف والتحيز.
التمييز متمثلًا في:
التمييز بمختلف أشكله الاقتصادية، والسياسية، والأحقية في التعليم، والعمل.
العنف بدافع التحيز متمثلًا في:
القتل، الاغتصاب، الاعتداء، الإرهاب، التخريب، التدنيس، التهديدات.
الإبادة الجماعية متمثلة في:
القيام بفعل أو النية للقيام بفعل إبادة شعب بأكمله بشكل منهجي ومتعمد.
بيئة العنصرية والكراهية في البيئة الرقميّة
يركز الخطاب الشعبوي ببعده السياسي على مركزية الشعب في الممارسة السياسية، حيث يسمح الخطاب الشعبوي في توظيف مشاعر الغضب عند عموم الجمهور في مختلف الأوقات وتحديداً خلال الأزمات، ولهذا يجد هذا الخطاب القبول حيث يسعى إلى جمع الجمهور بشكل عاطفي بعيدًا عن الأفكار، يميل إلى إثارة المشاعر ليتماشى مع المزاج السائد، حتى يبدوا الخطاب الشعبوي هو الخطاب السائد وهو في الحقيقة لا يعالج القضايا والمشاكل الواقعية.
كما تمكن مشكلة الخطاب الشعبوي أنه خطاب قائم على العنصرية يبحث بشكل مستمر عن أعداء جدد بشكل دائم لتوجيه الغضب ضدهم سواء كانوا “مؤسسات أو أفراد” ومن ثم بث الكراهية وشَيْطَنَتهم.
ولهذا من الصيغ المستخدمة ضمن الخطاب الشعبوي اعتماد صيغة الشعب أو الأمة الأصيلة مقابل ما يَعُدُّه دخيلًا. ومما تبين من خلال نتائج الدراسة للجهات التي تناولت مظاهر العنصرية في المجتمع الأردني؛ كانت هذه أبرز نتائج.
الجهات التي تناولت مظاهر العنصريّة
من خلال الرصد، بلغ إجمالي المنشورات 24,5333، والحسابات المشاركة 188,885، فيما بلغ إجمالي المشاهدات 86,233,726، والوصول المقدر 344,664,764. وضمن تحليل طريقة التفاعل كان إعادة النشر الأعلى وبلغ 62%، وتلاها الردود 24%، فيما تساوت الاقتباسات مع المنشورات وبلغت 7% لكل منهما