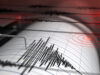صراحة نيوز – أنس أبو سنينه
بين صخور الصحراء الممتدة في جنوبه، وسهول الشمال التي كانت خضراء ذات يوم، يعيش الأردن اليوم واحدة من أخطر أزماته الوجودية: ندرة المياه. أزمة لا ترتبط فقط بالجغرافيا القاحلة أو تغيّر المناخ، بل تتشابك فيها عوامل السياسة، والتاريخ، والنمو السكاني، والصراعات الإقليمية.
الأرقام قاسية: حصة الفرد الأردني من المياه لا تتجاوز أحيانًا 80–100 متر مكعب سنويًا، في حين أن خط الفقر المائي العالمي هو 500 متر مكعب. ومع كل موجة جفاف، ومع كل زيادة سكانية، يزداد الخطر الذي يهدد الزراعة، والصناعة، وحتى الأمن الوطني.
خلفية تاريخية: أزمة متجذرة
لم تكن المياه في الأردن يومًا وفيرة. فالموقع الجغرافي في قلب المشرق العربي، ذي المناخ شبه الجاف، جعل الاعتماد على الأمطار والمصادر المحدودة أمرًا طبيعيًا. لكن منذ خمسينيات القرن الماضي، ومع تزايد السكان وتوسع المدن، بدأت المؤشرات المبكرة للأزمة بالظهور.
في السبعينيات والثمانينيات، جاء التحدي الأكبر من الموارد المائية المشتركة، وعلى رأسها نهر اليرموك، الذي تعتمد عليه المملكة بشكل أساسي. وبناء السدود في دول الجوار — خاصة سوريا — قلل من تدفق المياه نحو الأراضي الأردنية، بينما أدى تزايد الزراعة والاستخدام المحلي إلى استنزاف الخزانات الجوفية.
مع تسعينيات القرن الماضي، بدأت الحكومة الحديث عن “الفقر المائي” كمصطلح رسمي، وتحولت المسألة من قضية زراعية إلى قضية أمن قومي.
الأسباب المركّبة للأزمة
1. المناخ القاسي وتغير أنماط الطقس
• الأمطار في معظم مناطق الأردن أقل من 200 ملم سنويًا.
• موجات الجفاف باتت أطول وأكثر تكرارًا، وفق دراسات الأرصاد الجوية المحلية وتقارير المناخ العالمية.
2. النمو السكاني وضغط اللاجئين
• عدد سكان الأردن تضاعف مرات عدة خلال العقود الماضية.
• استقبال موجات كبيرة من اللاجئين من فلسطين، العراق، وسوريا، ضاعف الطلب على المياه في وقت قصير.
3. الاستنزاف المفرط للمياه الجوفية
• الضخ الجائر يفوق معدلات التغذية الطبيعية للطبقات الجوفية، ما يسبب انخفاضًا حادًا في المنسوب، وتملّح بعض المصادر.
4. البنية التحتية المتهالكة
• فاقد المياه في شبكات التوزيع يتجاوز في بعض المناطق 40–50% بسبب التسربات وسرقة المياه.
5. التحديات السياسية والإقليمية
• الأحواض المائية المشتركة مع سوريا وإسرائيل تخضع لعوامل سياسية وأمنية تعيق الوصول إلى حصص عادلة.
المعايير والأرقام: أين يقف الأردن اليوم؟
وفق الاستراتيجية الوطنية للمياه 2023–2040، تبلغ حصة الفرد السنوية من المياه في الأردن نحو 61 مترًا مكعبًا فقط من الموارد المتجددة، أي ما يقارب عُشر المعدل العالمي الآمن.
توصي منظمة الصحة العالمية بتوفير 100 لتر على الأقل للفرد يوميًا لتلبية الاحتياجات الأساسية، لكن في بعض المناطق الأردنية لا يتجاوز الاستهلاك 80 لترًا.
تقارير البنك الدولي تشير إلى أن الأردن بحاجة إلى استثمارات تفوق 3 مليارات دولار خلال العقد المقبل لتحديث البنية التحتية وتحلية المياه.
مسارات الحل: بين الطموح والواقع
1. مشروع الناقل الوطني (تحلية العقبة)
• يهدف إلى تحلية مياه البحر الأحمر وضخها إلى عمّان وبقية المحافظات.
• من المخطط أن يوفر 300 مليون متر مكعب سنويًا، وهو أكبر مشروع مياه في تاريخ المملكة.
2. إعادة استخدام المياه المعالجة
• الأردن من الدول الرائدة عربيًا في إعادة استخدام مياه الصرف الصحي المعالجة في الزراعة.
3. تقليل الفاقد المائي
• تحديث الشبكات القديمة وتطبيق أنظمة كشف التسربات.
4. إدارة الطلب الزراعي
• تقنيات ري حديثة مثل الري بالتنقيط، وتغيير أنماط المحاصيل.
5. التعاون الإقليمي
• اتفاقيات “الماء مقابل الطاقة” مع دول الجوار، والتفاوض على الحصص المائية.
السيناريو السوري: هل يمكن للأردن أن يحصل على مياه من سوريا بعد سقوط النظام؟
يُعدّ نهر اليرموك شريانًا مائيًا مشتركًا بين الأردن وسوريا، لكن السنوات الماضية شهدت انخفاضًا كبيرًا في تدفقه نحو الأردن، لأسباب بينها بناء سدود سورية صغيرة ومتوسطة، وزيادة الاستخدام المحلي هناك.
في حال سقوط النظام السوري وتشكيل حكومة جديدة، قد تكون هناك فرصة لإعادة التفاوض على اتفاقية 1987 الخاصة بتقاسم مياه اليرموك.
لكن الأمر ليس بهذه البساطة؛ فالاستفادة من هذه المياه تتطلب:
• إعادة تأهيل البنية التحتية على الجانب السوري.
• موافقة دولية وإقليمية على أي اتفاق جديد.
• مراعاة احتياجات السكان السوريين المحليين.
الخبراء يؤكدون أن أي “أخذ” للمياه لا يمكن أن يتم إلا عبر اتفاق قانوني ودبلوماسي، وإلا سيتحول إلى مصدر توتر إقليمي.
أزمة المياه في الأردن ليست أزمة عابرة أو مرتبطة بجفاف موسمي؛ إنها معركة طويلة الأمد تتطلب توازنًا بين إدارة الطلب وتأمين موارد جديدة، وبين التحرك الوطني والتعاون الإقليمي.
ومهما كانت السيناريوهات السياسية في الجوار، يبقى الحل في الداخل الأردني هو الأكثر واقعية: تحديث البنية التحتية، تحلية المياه، وإعادة الاستخدام بكفاءة، مع تعزيز ثقافة الترشيد بين المواطنين.
فالخيار اليوم ليس بين الوفرة أو النقص، بل بين إدارة الأزمة بحكمة أو مواجهة تداعياتها على الأمن الغذائي والاستقرار الوطني.